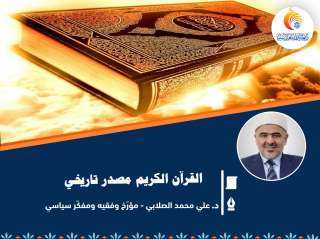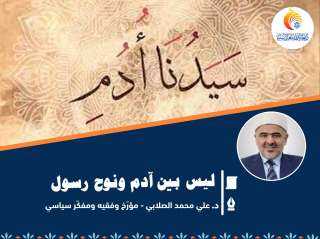اتفاق كامب ديفيد -2 والمستقبل الأمني بالخليج


تحتل منطقة الخليج العربي أهمية استراتيجية كبرى لدى الولايات المتحدة الأمريكية؛ نظراً لموقعها الاستراتيجي المحوري الواقع في المنتصف بين أوروبا وشرق آسيا، وامتلاكها لما يقرب من نصف نسبة احتياطي النفط في العالم، وهو ما أتاح للاستعمار البريطاني وقتها حرية حركة السفن الحربية والتجارة في موانئ إمارات "الساحل المتصالح"، التي أصبحت فيما بعد "دول مجلس التعاون الخليجي". وقد جمعت دولَ مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة علاقة شراكة، اقتضت أن تكون الولايات المتحدة هي الداعم العسكري القوي والمدافع عن دول الخليج ضد أية تهديدات عسكرية إقليمية في المنطقة، والشريك الرئيسي الخارجي لأية ترتيبات أمنية إقليمية في الخليج العربي.
وباندلاع ثورات الربيع العربي وإسقاطها للعديد من الأنظمة الديكتاتورية، التي اعتبرت اختباراً غير متوقع للعلاقات الأمريكية-الخليجية، وحدوث تحولات دراماتيكية للسلطة السياسية في العالم العربي، يمكن القول إن دول الخليج قد نجت من تلك الثورات وضجتها السياسية نتيجة لثرواتها الاقتصادية الهائلة، وسياساتها الموجهة نحو النمو الاقتصادي والتوظيف، إلا أن تركها في وضع متناقض لكونها الحصن الأخير المتبقي- بما في ذلك الأردن والمغرب- الذي لم يشهد ثورات شعبية. وعلى الرغم من ذلك، فإن الإطاحة بعدد من مراكز القوى السياسية والاقتصادية في المنطقة- أهمها مصر وسوريا- كان في مصلحة دول الخليج ونماء ثروتها النفطية.
وحري بالذكر أن العلاقات الأمريكية الخليجية قد شهدت توتراً ملحوظاً على إثر توقيع اتفاق لوزان بين الولايات المتحدة وإيران، المعني بتسوية أزمة البرنامج النووي الإيراني، وذلك دون إشراك أيٍّ من دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما أثار حفيظة الدول الخليجية التي ترى في هذا الاتفاق تهديداً صريحاً ومباشراً لها. ومن ثم دعا الرئيس الأمريكي الدول الخليجية إلى عقد اجتماع في منتجع كامب ديفيد من أجل طمأنة حلفائه الخليجيين.
وبناء على ما سبق، تتمحور المشكلة البحثية لهذه الدراسة حول المعضلة الأمنية التي تواجه الدول العربية بصفة عامة ودول الخليج بصفة خاصة، والمترتبة على البرنامج النووي الإيراني، إثر توقيع اتفاق جنيف في نوفمبر 2013، حيث تجد الدول الخليجية نفسها دون نظام للأمن يعتد به في حالة أي تراجع محتمل في الالتزامات الأمريكية بهذا الأمن، وغياب "الموازن الإقليمي" القادر على مواجهة ما هو قائم وما هو مستجد من التحديات والتهديدات، مما يعني انكشافاً استراتيجياً خليجياً- سيكون له حتماً مخاطره السياسية والاقتصادية والأمنية على الأمن الإقليمي الخليجي، وعلى الأوضاع الداخلية في الدول العربية الخليجية، وربما على مستقبل دول مجلس التعاون الخليجي.
مناهج الدراسة:
إن الظاهرة السياسية محل الدراسة هي التي تحدد المنهج المناسب لمعالجتها، ونظراً لصعوبة القول بأن هناك منهجاً واحداً يصلح لدراسة ظاهرة سياسية ما، نظراً لما تتسم به من تعدد الأبعاد، فقد اعتمدت الدراسة على الاقترابات المنهاجية التالية:
1- الاقتراب النظمي: (System approach)
فمن خلال منهج النظم يمكن دراسة أهداف النظام السياسي والوحدات المكونة له وتفاعلها فيما بينها أو بين النظام كوحدة واحدة وبين البيئة الخارجية، وكيف يحافظ النظام على ذاته. ويعتقد بعض علماء العلاقات الدولية أن منهج النظم هو المنهج الوحيد المتاح الذي يستطيع الإلمام بمختلف المتغيرات التي تؤثر في الحركة السياسية الدولية من خلال دراسة التفاعل والاعتماد المتبادل بين الدول أعضاء النظام الدولي.
ويوفر هذا المنهج المعيار القياسي اللازم لشرح السياسة الدولية الذي من شأنه زيادة فهم الظاهرة محل البحث، وزيادة قدرة الباحث على التنبؤ والضبط نتيجة للشمول والدقة في صياغة القوانين.
2- اقتراب صنع القرار (Decision making approach) :
يؤكد منهج صنع القرار على أن القرار يتم اتخاذه في إطار واقع اجتماعي من ناحية وسياسي من ناحية أخرى. أما الواقع الاجتماعي فيشمل المتغيرات التي منها الرأي العام والقوى الاجتماعية والتيارات العقائدية. أما الإطار السياسي فيضم مجموعة القواعد والمنظمات التي تشكل الحكومة، وهذا الواقع بجوانبه الاجتماعية والسياسية يؤثر ويتأثر بسلوك صانعي القرار، مع ملاحظة أن آلية صنع القرار تتجاوز الإطار الدستوري الشكلي إلى التعرف على الأشخاص المعنيين المشاركين في عملية صنع القرار.
3- الاقتراب التاريخي: (Historical approach)
لا يكاد يخلو بحث علمي من المنهج التاريخي؛ لأهميته في كشف تطور الظاهرة عبر الزمان والمكان، خاصة أن العلاقات الدولية تقوم على التنبؤ بمستقبل الظاهرة، التي لا يمكن التنبؤ بها دون معرفة تاريخها.
تقسيم الدراسة:
سنقوم بتقسيم الدراسة إلى المحاور التالية:
المحور الأول: أسباب انعقاد قمة كامب ديفيد.
المحور الثاني: مطالب الأطراف المختلفة في قمة كامب ديفيد.
المحور الثالث: وقائع قمة كامب ديفيد 2.
المحور الرابع: مستقبل الخليج العربي بعد قمة كامب ديفيد.
خاتمة الدراسة.
المحور الأول: أسباب انعقاد قمة كامب ديفيد
ترجع أسباب الدعوة إلى عقد قمة كامب ديفيد بين الدول الخليجية والولايات المتحدة الأمريكية إلى استشعار الولايات المتحدة بقلق الدول الخليجية نتيجة لمواجهتها عدة تحديات، التي يمكن إيجازها على النحو التالي:
أولاً: التحديات النابعة من البيئة الدولية
تتمثل فيما يلي:
أ- تراجع أهمية منطقة الشرق الأوسط بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ولسياساتها الخارجية:
إذ صرحت مستشارة الرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي السابقة "سوزان رايس" في ذلك في إشارة إلى الشرق الأوسط: "ليس بمقدورنا أن يستغرق إقليم واحد وقتنا كله، أياً كانت أهميته، ويرى الرئيس أن الوقت مناسب لخطوة للوراء وإعادة التقييم، بطريقة نقدية وغير متزمتة حول كيفية إدراكنا لمكانة إقليم معين. وإن هدف الرئيس هو تجنب أن تبتلع الأحداث في الشرق الأوسط كل أجندة أعمالنا كما كانت عليه الحال مع الرؤساء قبله"([1])، وهو ما يعني أن مكانة الشرق الأوسط ستتأثر بشكل سينعكس على المنطقة من خلال بعدين؛ الأول: تحول في طبيعة التحالفات من ناحية، وفتح المجال للقوى الإقليمية من ناحية ثانية لاستثمار هذا التحول طبقاً لمعطيات القوة فيها؛ وهو أمر قد ينعكس بمزيد من التوتر بين القوى الإقليمية([2]). وحري بالذكر أن تراجع أهمية الشرق الأوسط بالنسبة للولايات المتحدة يرجع إلى الآتي:
1- انتهاء الحرب الباردة: إذ إنه خلال الحرب الباردة بين القطبين الروسي والأمريكي كانت الولايات المتحدة بحاجة إلى نفوذ سياسي وعسكري في منطقة الشرق الأوسط بالأساس للقضاء على خطر النفوذ الروسي والحد منه. بيد أن الحرب الباردة، وإن كانت قد انتهت رسمياً قبل عقود، انتهت عملياً خلال السنوات الأخيرة، ويؤكد انتهاء هذه الحرب شواهد عديدة، من بينها عدم تصعيد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع واشنطن، على الرغم من إزالة أمريكا لأهم حلفاء روسيا في المنطقة، وهو الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، وكذلك الدور الذي قامت به أمريكا في الإطاحة بالحليف الآخر للروس وهو معمر القذافي.
2- تعاني الولايات المتحدة فعلياً من عجز متزايد في موازنتها، وتضخم هائل في المديونية العامة للحكومة الفيدرالية تعدى هذا العام 18 تريليون دولار، أي ما يعادل 103% من الناتج القومي، وهو ما يجعل أية مغامرة عسكرية عبئاً مالياً يصعب الوفاء به.
3- تعزيز نزعة الاستقلال الطاقوي: لقد تبنى الرئيس أوباما هذه الاستراتيجية، ومع أنه تم تبنيها سابقاً في الأعوام 1974-1977، والأعوام 1984-1989، فإن النتائج لم تكن مشجعة، غير أن بعض المؤشرات الجديدة في هذا الحقل تشير لنزوع أمريكي باتجاه مسألتين: تخفيف تدريجي من الاعتماد على نفط الشرق الأوسط، فقد انخفضت الواردات الأمريكية من نفط الخليج من 1.007 مليون برميل عام 2001 إلى 789.082 برميلاً، أي بتراجع قيمته 218.725 برميلاً. ثم من ناحية ثانية، تقليص واردات النفط بشكل عام، وقد كانت الولايات المتحدة تستورد 60% من حاجتها عام 2005، وهي تستورد حوالي 40% حالياً، ويأتي أكثر من 50% منه من الأمريكتين (كندا وأمريكا الجنوبية والوسطى)([3]).
4- عدم رغبة أمريكا في التورط عسكرياً في المنطقة: حيث قللت الإدارة الأمريكية من اعتمادها على قوتها العسكرية وتدخلها المباشر في شؤون العالم؛ وذلك بسبب وجود حالة انصراف شعبي واسع عن فكرة التورط في حروب جديدة، فقد تركت حروب بوش انطباعاً شعبياً وسياسياً عميقاً بضرورة تفادي مثل هذه المغامرات مستقبلاً، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن غالبية الأمريكيين لا يؤيدون تدخلاً عسكرياً أمريكياً لا في أوكرانيا ولا أفغانستان ولا العراق ولا سوريا. ومن المهم التأكيد أن هذا التوجه ليس مرتبطاً بإدارة أوباما، بل هو توجه فعلي للمجتمع والدولة الأمريكية، وإذا انتخب رئيس جمهوري فلن يتمكن من تغيير هذا التوجه، لا سيما بفعل الأزمة الاقتصادية المستمرة ورغبة الأمريكيين في تدخل أقل في شؤون العالم الخارجي.
ثانياً: التحديات النابعة من البيئة الإقليمية:
تواجه دول الخليج العربية تحدياتٍ أمنية عديدة في الوقت الراهن، يمكن إجمالها فيما يلي:
أ- التحدي الإيراني: ويكمن هذا التحدي في العناصر التالية:
1- الثورة الإيرانية: يشير المتخصصون إلى أن نجاح الثورة الإيرانية عام 1979 هو الذي دفع دول الخليج العربي الست إلى إيجاد نظام إقليمي دفاعي أمني كمحاولة لدرء الأخطار عنها، خاصة دفع خطر تصدير الثورة التي كانت إيران تهدد به جيرانها في ذلك الوقت([4]). وقد ارتأت إيران أن الوجود العسكري الأمريكي المكثف في دول مجلس التعاون الخليجي كان وما زال هو المصدر الأهم لتهديد أمنها القومي([5]). وفي مقابل الوجود العسكري الأمريكي في الخليج العربي، قامت إيران بمحاولات لطرح رؤيتها الخاصة بترتيبات أمن الخليج كبديل عن هذا الوجود، وهي نابعة من مبدأ أن الدول المطلة على الخليج هي التي يجب أن تقوم بحمايته[6]. لكن هذه الطروحات لم تلق آذاناً مصغية من دول الخليج التي فضلت البديل الأجنبي محدداً في الوجود العسكري الأمريكي بالمنطقة[7].
2- البرنامج النووي الإيراني: وقد بدأ هذا البرنامج برعاية أمريكية وقد كان يمثل جزءاً من جهود الشاه الرامية إلى تحويل إيران إلى قوة إقليمية عظمى، حيث كان الشاه يعتمد بقوة على الولايات المتحدة لدعم حكمه ولمساعدته في تحقيق التنمية والنهضة الشاملة التي كان يطمح إليها، كما ترافق ذلك مع قيام الجانبين بتطوير درجة عالية من التعاون السياسي والاستراتيجي، بحيث أصبح نظام الشاه حليفاً للولايات المتحدة في حربها الباردة ضد الاتحاد السوفييتي السابق والكتلة الاشتراكية[8]، ويذكر أن التعاون النووي بين إيران والولايات المتحدة قد استهل من خلال برنامج الذرة من أجل السلام(*) الذي على أساسه وقعت إيران في عام 1957 مع الولايات المتحدة اتفاقية للتعاون النووي في المجالات المدنية، مدتها عشر سنوات، حصلت إيران بموجبها على مساعدات نووية فنية من الولايات المتحدة، وعلى عدة كيلوجرامات من اليورانيوم المخصب للأغراض البحثية، كما تعاون الجانبان في البحوث المتعلقة بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية([9]). إلا أن هذا التعاون قد توقف على إثر قيام الثورة الإيرانية سنة 1979، حيث تجاهل نظام الحكم الثوري البرنامج النووي بصورة شبه كاملة في السنوات الأولى لقيام الثورة، ولم يكن هذا التجاهل عائداً فقط إلى طبيعة الأولويات التي كانت تحكم هذا النظام، لا سيما فيما يتعلق بإعطاء الأولوية لتأمين الثورة وحمايتها ونشر مبادئها وأفكارها في المحيط الإسلامي، بل كان عائداً في الوقت نفسه إلى شيوع قناعات فكرية محددة لدى قادة الثورة (وبالأخص الإمام آية الله الخميني) لا تعطي اهتماماً كبيراً للقضايا المرتبطة بالطاقة النووية، وهذه القناعات كانت تنبع غالباً من عدم الإدراك الصحيح بالإمكانيات العلمية والاستراتيجية التي يوفرها امتلاك خبرات وقدرات هامة في المجال النووي([10]). إلا أنه سرعان ما شرعت إيران في إحياء برنامجها النووي بعد سنوات من اندلاع الحرب العراقية-الإيرانية. وبعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية تزايدت جهود طهران في المجال النووي؛ حيث ركزت تلك الجهود وقتذاك على اتجاهات محددة تتمثل في: استكمال محطة بوشهر للطاقة النووية، واستكمال البنية النووية الأساسية، والعمل على استعادة الطواقم البشرية العاملة في المجال النووي، ومواصلة إجراءات التقاضي لتسوية الخلافات حول الصفقات التي كان نظام الشاه قد أبرمها مع الشركات الفرنسية، والتعاون مع أكبر عدد ممكن من الدول في المجالات النووية، وقد اعتمدت إيران في ذلك الوقت بقوة على كل من الاتحاد السوفييتي والصين بعد أن فشلت جهودها في استئناف التعاون مع دول غرب أوروبا([11])، ومن ثم عملت إيران منذ ذلك الحين على أن تمتلك بنية أساسية كافية لإجراء الأبحاث النووية المتقدمة، وقامت الحكومة بنشر المنشآت النووية الاستراتيجية على مساحة واسعة، وأحاطتها بجدار هائل من السرية، وذلك تحسباً لأية ضربات عسكرية([12]). وليس بخاف إصرار الرئيس الإيراني آنذاك أحمدي نجاد على استكمال أركان البرنامج النووي الإيراني مبرراً ذلك بما يلي من اعتبارات([13]):
تطلع إيران إلى تملك طاقة نووية للاستخدام السلمي على نحو يمكنها من زيادة حصة صادراتها النفطية المستجلبة للعملة الصعبة.
رغبة إيران الإفادة من التكنولوجيا النووية المتقدمة في مجال الصناعة لبناء كوادرها المتخصصة في هذا الحقل المعرفي الشديد الأهمية.
حق إيران - وفقاً لنصوص اتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية- في تخصيب اليورانيوم محلياً، بما يوفر لها اكتفاء ذاتياً ويحررها من مغبة الاعتماد على الخارج في هذا المضمار الذي كثيراً ما تتلون مواقفه بمآرب سياسية.
إن إيران تكبدت كلفة مالية باهظة لتأسيس بنية تحتية نووية لأغراض سلمية أصبحت رمزاً للعزة والكرامة التي لا سبيل للمساس بهما.
أن تمتلك إيران قدرات نووية سلمية هو من قبيل المطلب الجماهيري، سواء إبان حكم الشاه أو حالياً.
خريطة توضح أهم المواقع والمنشآت النووية الإيرانية[14].
بيد أنه هناك تخوفاً عربياً وخليجياً ملحوظاً من امتلاك إيران سلاحاً نووياً تعتبره ذا تأثير فاعل يُخلّ في نوع التوازن والاستقرار الإقليمي، ولدرجة قد تؤدي إلى نفوذ كبير لإيران في منطقة الشرق الأوسط على حساب مصالح الدول العربية المختلفة، وهذا من شأنه أن يهدد وجود الأنظمة السياسية العربية القائمة ومكونات الأمة الإسلامية، لكون إيران لها موروث تاريخي يستند إلى الرغبة في تدشين إمبراطورية فارسية تتنافس بها مع التوجهات التركية الصاعدة، خاصة بعد وصول حزب "العدالة والتنمية" للسلطة في تركيا عام 2002، ونظراً لغياب مشروع عربي له القدرة على المواجهة، باتت معظم الدول العربية عامة، والخليجية خاصة- نتيجة لتشعب توجهاتها وانقساماتها وتغليب المصالح القطرية على مشروع التكامل الإقليمي- تعمل على تقوية مواجهتها من خلال تدشين اتفاقيات أمنية ثنائية مع الدول الأجنبية، وتفعيل إمكاناتها العسكرية بتزويد ميزان المدفوعات العسكري لشراء الأسلحة، خاصة من الولايات المتحدة والدول الأوروبية والصين، كما أنها تبحث عن وسائل تدفع بالتأثير الدولي على إيران لمقاومة مشروعها النووي وٕاضعاف استمراريتها في تخصيب اليورانيوم، بغض النظر عن إعلان إيران بأن برنامجها يحمل الطابع السلمي وليس لإنتاج السلاح النووي، مع إدراكها بأن قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بتحجيم توجهات إيران عن طريق نهج الحصار الاقتصادي يؤثر حتماً في فاعلية أداء الميزان التجاري عند الدول العربية، إلا أنها ترى أولوية الملف الأمني في المنطقة يجب أن يبقى ضمن الاستراتيجية الآنية والمستقبلية لديها.
3- التوصل إلى اتفاق لوزان في 2 أبريل 2015: الذي تم بين إيران من جهة ومجموعة 5+1 تمهيداً للتوقيع على الاتفاق النهائي في 30 يونيو 2015، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تسوية أزمة الملف النووي الإيراني. وقد بدأت هذه الجهود منذ عام منذ عام 2003 في إطار ما عرف بجهود دول الترويكا الأوربية (ألمانيا- بريطانيا- فرنسا)، وقد مرت بعدة مراحل، من أهمها اتفاقية طهران في 21 أكتوبر 2003، تلتها اتفاقية باريس 7 نوفمبر 2004، ثم تلتها عدة جولات منذ يناير 2005 حتى نهاية ذلك العام. بيد أن إيران رفضت أغلب المقترحات الأوروبية، ليس فقط لأنها جاءت خالية تماماً من الاعتراف بحق إيران في تخصيب اليورانيوم، بل لأنها قامت في جوهرها على مطالبة إيران بالامتناع الكامل عن ممارسة هذا الحق، ومن ثم فهي لا قيمة لها بالنسبة لإيران. ذلك أن الحق في تخصيب اليورانيوم يعتبر مسألة محورية من وجهة النظر الإيرانية، سواء بحكم نصوص معاهدة حظر الانتشار النووي، أو في ظل الاحتياجات الوطنية الإيرانية([15]). ونتيجة لذلك فإن المفاوضات بين دول الترويكا الأوروبية وإيران بشأن الملف النووي الإيراني قد توقفت في أواخر عام 2005، وأنه أصبحت هناك صيغة جديدة للمفاوضات (وذلك بناء على الطلب الإيراني الخاص بضرورة توسيع رقعة المفاوضات)، وهي ما عرف باسم مفاوضات مجموعة (5+1)، التي ضمت إلى جانب دول الترويكا الأوروبية الولايات المتحدة وروسيا والصين، ومن ثم فإن جهود دول الترويكا الأوروبية أضحت جزءاً لا يتجزأ من جهود مجموعة (5+1)([16]). ومع توسع رقعة المفاوضات، تزايد الحديث عن دور أمريكي مباشر، تزامن أيضاً مع تغيير وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون، إذ تسلّم جون كيري رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس منصب وزير الخارجية. وقد مثّل تسلم كيري الوزارة بداية مرحلة في الخيار الدبلوماسي المتعلّق بالمسألة النووية الإيرانية. كانت هذه المرحلة تستذكر تجربة التفاوض الأمريكي مع كوريا الشمالية التي نتج عنها "اتفاق الإطار"، الذي تمّ توقيعه في العام 1994، وترتّب عليه إغلاق مفاعل يونغبيون حتى العام 2002، لكن النموذج الكوري كان هو الذي يُنظر إليه بوصفه محاولة لتقديم حلول مرحلية يمكن أن يُبنى عليها للوصول إلى حلٍّ سياسي لمعضلة الملف النووي الإيراني.
بعد فرض سلسلة من العقوبات على إيران، وكذلك التغيرات التي طرأت على المشهد الإقليمي والدولي بعد الربيع العربي، تعثّرت الجهود الدبلوماسية، وكان السبب بالنسبة إلى إيران، ولا سيما في ظل رئاسة محمود أحمدي نجاد، تنامي أجواء عدم الثقة بالوسيط الأوروبي أو الوسيط التركي-البرازيلي. من هنا وأمام فترة السكوت المتعلّقة بالملف النووي في الأعوام 2010- 2012 كان الطرفان؛ الأمريكي والإيراني، يأملان في وسيط يمكن أن يضخّ بعض الدماء في مسارات الدبلوماسية المتعثّرة آنذاك، ويبدو أنّ البحث عن وسيط كان مرتبطاً بالتأثير الذي تركته العقوبات في الاقتصاد الإيراني([17]) والتقديرات الغربية والأمريكية، تزامن ذلك أيضاً مع انتهاء رئاسة أحمدي نجاد، كل هذه المؤشّرات كانت تدفع إيران للعودة إلى خيار التفاوض، وقد شجّع على ذلك تولّي الرئيس حسن روحاني رئاسة الجمهورية في إيران؛ إذ بعث رسائل سياسية إلى الغرب، شجّعت الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين للعودة إلى خيار التفاوض[18]، حيث بدا واضحاً أنّ مسألة التفاوض حول الملف النووي الإيراني لن يحسمها إلا المفاوضات المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشكل أساسي إضافة إلى الدول الكبرى الأخرى.
لقد كان اتفاق جنيف المبدئي الذي تمّ توقيعه في نوفمبر 2013، دليلاً عملياً على أنّ الوساطات لن يتجاوز دورها مرحلة خلق أجواء من الثقة، وتهيئة الأطراف للمفاوضات المباشرة، وهو أمر نجحت عُمان في فعله، ولا سيما بين واشنطن وطهران. إنّ التوصّل إلى اتفاق جنيف لم يكن بعيداً عن تأثير الوساطة العمانية التي ساعدت على خلق أجواء الثقة بين إيران والولايات المتحدة، وهو الأمر الذي كان ينقص في جولات التفاوض التي جرت منذ عام 2003. وقد استمر الجانبان الإيراني والأمريكي في الانخراط في الحوار المباشر منذ نوفمبر 2013 حتى تم التوصل إلى اتفاق لوزان في الثاني من أبريل 2015 تمهيداً لتوقيع اتفاق نهائي في 30 يونيو، إلا أنه تم توقيع الاتفاق في 14 يوليو 2015.
وفيما يلي عرض لأهم بنود اتفاق لوزان:
-وافقت إيران بموجب الاتفاق المبدئي على تقليص مخزون اليورانيوم منخفض التخصيب البالغ 10000 كيلوجرام إلى 300 كيلوجرام.
– تضمن موافقة طهران على عدم تخصيب اليورانيوم فوق معدل 3.67 بالمئة لمدة 15 عاماً على الأقل، على أن يتواصل التخصيب بموقع نطنز وليس في فوردو.
– من المقرر أن تستمر عمليات التفتيش المشددة لسلسلة إمداد اليورانيوم في إيران 25 عاماً بموجب الاتفاق المبدئي.
– تعهدت إيران بموجب الاتفاق الإطاري بعدم تصنيع البلوتونيوم بدرجة تسمح باستخدامه في صنع الأسلحة النووية في مفاعل آراك.
– تعهدت القوى الكبرى والاتحاد الأوروبي برفع العقوبات الاقتصادية والحظر على صادرات النفط الإيراني بحسب مدى التزام طهران بالاتفاق النووي.
- العقوبات الأمريكية على إيران بسبب الإرهاب وانتهاكات حقوق الإنسان والصواريخ طويلة المدى ستبقى بموجب الاتفاق النووي المستقبلي إن تم الاتفاق عليه في نهاية يونيو. وشمل الاتفاق رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية فور تأكيد الوكالة الدولية للطاقة الذرية احترام إيران لتعهداتها، ويعاد فرض هذه العقوبات إذا لم يطبق الاتفاق.
جدير بالذكر أنه كان من المقرر أن يتم رفع كل العقوبات المفروضة بموجب قرارات صادرة عن مجلس الأمن الدولي ما إن تحترم إيران كل النقاط الأساسية في الاتفاق، ويبقي قرار جديد للأمم المتحدة الحظر على نقل التكنولوجيا الحساسة ويدعم تطبيق هذا الاتفاق، ومن ثم يمكن القول بأن هناك خشية لدى الدول الخليجية من أن يؤدي هذا الاتفاق إلى الإخلال بمستقبل التوازنات في المنطقة لمصلحة إيران، وترجيح كفتها على حساب كفة دول الخليج العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية.
4- الدور الإيراني المتصاعد في إذكاء الصراع الطائفي في المنطقة: وخاصة في أعقاب الغزو الأمريكي للعراق، حيث طرحت إيران مشروعها على المنطقة العربية لإقامة شرق أوسط إسلامي في مواجهة المشروعات التي طرحتها الولايات المتحدة الأمريكية عقب احتلال العراق عام 2003، مثل مشروع "الشرق الأوسط الكبير" و"الشرق الأوسط الجديد". ويعتمد هذا المشروع الإيراني على محورين: الأول أيديولوجي يتمثل في إيمان النظام الإيراني بحتمية قيام الحكومة العالمية للإسلام، وبضرورة اضطلاع إيران بدور قوي في التمهيد لذلك، طبقاً لما جاء في الدستور الإيراني. والثاني استراتيجي يتصل بمحاولات إيران تكوين حزام أمني يكون بمنزلة حائط صد لكل المحاولات التي يبذلها خصومها لاختراقها من الداخل أو إحكام محاصرتها عبر دول الجوار([19]). حيث ظهرت في هذه المرحلة بشكل واضح ساحات إيرانية في مناطق من العالم العربي، تتمثل في كل من دول الخليج ولبنان وفلسطين والعراق واليمن، ولها مظاهر من النفوذ الإيراني في المجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية ازدهرت في فترة الاحتلال الأمريكي للعراق بعد أن خلَّف الاحتلال محاصصات طائفية؛ كتمثيل الشيعة والأكراد كأطراف رئيسية في الهياكل والمؤسسات الحكومية، وهو ما فتح المجال لإيران للتواصل مع القوى السياسية في العراق، خاصة مع حركات المقاومة المسلحة، وتلك المنخرطة في العملية السياسية، كما أسهم ذلك في توقيع العديد من الاتفاقيات الاقتصادية كحق التنقيب عن النفط والاستثمار بهذا المجال. ونشطت إثر ذلك حركة التبادل التجاري بين الطرفين، كما دفعت إيران ببعض الأطراف العراقية لمنع توقيع الاتفاقية الأمنية بين الولايات المتحدة والعراق، إذ عارضها التيار الصدري، وجعلت من الاتفاقية ذات سمة ضعيفة لكونها أقرت بموافقة (144) عضواً من أعضاء البرلمان العراقي، لأن إيران كانت تحرض العديد من النواب العراقيين على عدم حضور جلسات البرلمان. كما استخدمت إيران المتغير الثقافي في نفوذها داخل العراق، وذلك بتشييد المستشفيات والمدارس والأماكن الدينية، واستخدام اللغة الفارسية في عدد من مناطق العراق خاصة في إقليم البصرة، والدفع بسكان هذا الإقليم لاستقلاله بصورة مماثلة كما هو إقليم كردستان في شمال العراق.
كما يتجلى النفوذ الإيراني في لبنان من خلال دعم (حزب الله) الذي بات يتنامى بشكل فاعل كحركة اجتماعية وأمنية وقوة سياسية ممثلة في الحكومة والبرلمان، وهو ما مكن الدور الإيراني ليكون ذا نفوذ، وطرفاً حاضراً في كل الأزمات السياسية التي ما زالت تمر بها الجمهورية اللبنانية. واقتصادياً هناك العديد من المؤسسات التنموية الإيرانية في لبنان كمؤسسات تقوم بإعادة الإعمار وتعويض المتضررين ورعايتهم بعد العدوان الإسرائيلي على لبنان عام (2006)، وهذا بدوره يعطي لإيران قوة تجاه حسابات الصراع مع الولايات المتحدة والمجتمع الأوروبي وإسرائيل في مواجهة برنامجها النووي. وكذلك الحال من موقف إيران من الوضع في اليمن، وقيام إيران بدعم الثورة اليمينة وتأييد (الحوثيين) شمال اليمن في التمرد والمطالبة بالانقسام، وتقديم الدعم العسكري لهم من قبل إيران، خاصة بعد أن أعلنت الحكومة الإيرانية تحفظها الشديد إزاء أسلوب المواجهة الذي استخدمته اليمن والمملكة السعودية ضد الحوثيين خلال السنوات الأخيرة، كما أدانت إيران عملية عاصفه الحزم في مارس 2015 التي قامت بها قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، والتي شنتها على أهداف عسكرية لجماعة الحوثيين وارتأت إيران أن مثل هذه العملية تمثل تدخلاً في شؤون اليمن الداخلية. كما تتهم دول مجلس التعاون الخليجي إيران بالتدخل في شؤونها الداخلية من خلال التحريض الطائفي على الأنظمة السياسية، خاصة في البحرين والكويت والسعودية، حيث تحرض وسائل الإعلام الإيرانية الجماعات الشيعية في تلك الدول الخليجية على مواجهة الأنظمة الحاكمة ضمن فكر الحرية والتحرر، وليتزامن ذلك مع الثورات الداخلية التي شهدتها العديد من الدول العربية.
المحور الثاني: مطالب الأطراف المختلفة في قمة كامب ديفيد2
الطرف الأمريكي: لقد دعا الرئيس باراك أوباما نظراءه الخليجيين إلى اجتماع كامب ديفيد نظراً لاستيائهم من السياسات التي يتَّبعها في المنطقة، لا سيما فيما يخصُّ تعامل إدارته مع الملف النووي الإيراني (التي ذكرناها آنفاً)، وكذلك السياسات التي تتَّبعها الحكومة الأمريكية لمعالجة القضايا الأمنية التي تخصُّ المنطقة؛ لا سيما في العراق واليمن وسوريا وليبيا، دون إغفال القضية المركزية للأمَّتين العربية والإسلامية؛ "القضية الفلسطينية"([20]). حيث ارتأى الرئيس أوباما أن الوقت قد حان لإطلاع حلفائه الخليجيين على خفايا الاتفاق الإطاري الخاص بالبرنامج النووي الإيراني؛ الذي تمَّ التوصل إليه في الثاني من أبريل 2015 في لوزان السويسرية، ولطمأنتهم على التبعات التي ستترتَّب على مثل هذا الاتفاق، لا سيما أن الغرب (في ذلك الوقت) كان يسعى إلى توقيع اتفاق نهائي مع إيران قبل نهاية شهر يونيو 2015، ولتهيئة المسرح الإقليمي لقبول هذا الاتفاق، وما قد ينجم عنه من تداعيات قد تؤرخ لبدء حقبة جديدة في الشرق الأوسط. وقد تم التوقيع على الاتفاق النهائي في 15 يوليو 2015، الأمر الذي اعتبر إنجازاً تاريخيّاً للرئيس أوباما؛ الذي يستعدُّ لمغادرة البيت الأبيض بعد إجراء الانتخابات الرئاسية التي ستشهدها الولايات المتحدة الأمريكية في نوفمبر 2016.
وقد اختار أوباما منتجع كامب ديفيد نظراً لارتباط هذا الاسم في أذهان العرب تحديداً بمفردة "المفاوضات" وبمصطلح "محادثات السلام"؛ ففي كامب ديفيد عُقد مؤتمر للسلام وُقعت خلاله اتفاقية إطار في عام 1978 بين مصر وإسرائيل في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وفيها أيضاً عُقدت قمة فلسطينية-إسرائيلية عام 2000؛ وذلك لإيجاد حلٍّ سلمي للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي؛ ولكنها لم تُكَلَّل بالنجاح.
الطرف الخليجي: فقد أتى إلى كامب ديفيد لتحقيق جملة من المطالب، وهي كالتالي:
أولها: الندِّيَّة مع إيران
يرى القادة الخليجيون بعد اتفاق لوزان (الآنف الذكر) الموقع بين الولايات المتحدة وإيران أن فيه تهديداً صريحاً لدول الخليج العربي، ومن ثم فهي في أمسِّ الحاجة إلى احتواء هذه التداعيات، والحد من انعكاساتها عليها، بالإضافة إلى ضمانات أمنّية حقيقيّة وفعّالة في وجه أي سياسات عدوانية أو توسّعية دأبت طهران على اتّباعها منذ عقود ولاسيما في السنوات الأخيرة([21]). وبناء على ذلك فقد ارتأت الدول الخليجية ضرورة دعم الولايات المتحدة الأمريكية لها من أجل حفظ التوازن الإقليمي في المنطقة؛ وذلك لن يتأتى إلَّا من خلال أن يكون لدول الخليج العربي ما سيكون لإيران؛ هذا هو الحدُّ الأدنى الذي يُتوقَّع أن يقبله قادة دول الخليج إذا ما أرادوا لدولهم أن تؤدِّيَ دوراً رئيساً في إعادة رسم خريطة التوازنات الجيوسياسية والجيوستراتيجية في المنطقة. لسنا هنا بصدد الحديث عن سباق لامتلاك التقنيات النووية في المنطقة؛ ولكن إذا ما أُجيز لإيران أن تمتلك الحقَّ في امتلاك القدرات النووية لأغراض سلمية، فلدول الخليج الحقُّ نفسه حتى يحدث التوازن المطلوب.
ثانيها: ضمان أمن الخليج
لدول الخليج حدودٌ جغرافيةٌ طويلةٌ مع كلٍّ من العراق شمالاً واليمن جنوباً، وكلتا الدولتين تعاني وضعاً أمنيّاً غير مستقرٍّ؛ فالعراق يشهد توترات مزمنة منذ اجتياح القوات الأمريكية له عام 2003، كما يشهد- أيضاً- صراعاتٍ طائفيةً لا يمكن تجاهلها، وقد استفحل الوضع فيه بعد أن سيطر مقاتلو تنظيم داعش على أكبر مدنه شمالاً (الموصل) صيف العام الماضي.
كذلك يشهد اليمن توتراتٍ لا تقلُّ خطورةً عن تلك التي يشهدها العراق، وقد تطور الوضع الميداني سوءاً في اليمن بعد أن استولت ميلشيا جماعة الحوثي على مفاصل الدولة، وأطلقت ما سُمِّي بالإعلان الدستوري في فبراير 2015، وهو ما عُدَّ انقلاباً على الشرعية الدستورية في البلاد، وتهديداً للأمن الوطني والإقليمي على حدٍّ سواء؛ وهو ما أدَّى إلى قيام قوات التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية بشنِّ حربٍ عسكرية على جماعة الحوثي والميلشيات الموالية للرئيس المخلوع علي عبد الله صالح بهدف إعادة الشرعية، وإجبار الخارجين عنها للعودة إلى طاولة المفاوضات.
في كلتا الحالتين أدَّت إيران- ولا تزال- دوراً جوهريّاً في إذكاء الصراعات في كلا البلدين؛ وذلك من خلال دعم حلفائها والموالين لها بكافة السبل والوسائل؛ وهو ما أدَّى إلى عدم الاستقرار في هاتين الدولتين الحدوديتين مع دول الخليج، وبالمحصلة فقد أدَّى ذلك إلى حالةٍ من عدم الاستقرار في المنطقة برمتها.
وبناء على ما سبق تطالب دول الخليج العربي بضمان أمن دولهم من خلال ضمان استقرار دول الجوار، وهنا يمكن بلورة المطلب الثاني لإدارة الرئيس أوباما من خلال العمل مع دول الخليج لتحقيق أمن واستقرار الإقليم، بل إن دول المجلس تريد شيئاً مكتوباً ويحمل التزاماً حقيقياً وليس شكلياً؛ إذ نُشِرت عدّة تقارير تقول إنّ سفير دولة الإمارات العربية المتّحدة في واشنطن "يوسف العتيبي"، كان قد قال إنّ دول مجلس التعاون تسعى للحصول على ضمانات أمنّية نظراً لسلوك إيران في المنطقة، وأنّها كانت تستند إلى نوع من الاتفاق الأمني الشفهي مع الولايات المتّحدة، لكنها تحتاج اليوم إلى شيء مكتوب، شيء مؤسساتي.
هذا يعني أنّ دول المجلس اختارت السقف الأعلى من الضمانات وهو أمر سيضع مصداقية أوباما تحت الاختبار. من غير المتوقع أن يوافق أوباما على هذا الطلب، ولا حتى على خيار "اتفاق أمني حقيقي"، وفي حال حصول ذلك فستكون مفاجأة كبيرة على اعتبار أن هذين الخيارين يتناقضان مع سياساته من جهة، وكذلك بسبب العقبات العملية التي قد تحول دون الموافقة على أحدهما، وهذا ما أكّده أيضاً العديد من الخبراء المقربين منه ومن إدارته في سياق التعقيب أو حتى الرد على المطلب الذي صرّح به السفير الإماراتي في واشنطن. في جميع الأحوال، التجربة السابقة تثبت أنّه باتفاق لتقديم ضمانات أو من دون اتفاق، لا يمكن الوثوق بوعود أو تعهّدات إدارة أوباما التي تمّ اختباراها على مدى السنوات الماضية بشكل جدّي وحاسم. هذه الإدارة لديها انجذاب غير مفهوم نحو إيران، وهي تراهن على الورقة الإيرانية. وحتى لو افترضنا تقديمه لضمانات أمنيّة مكتوبة لدول مجلس التعاون الخليجي، فمن المفيد عندها أن يقرأ قادة دول المجلس اتفاق الضمانات الأمنّية التي قدمتها الولايات المتّحدة مع غيرها من الدول لأوكرانيا عام 1994 في مقابل تخليها عن أسلحتها النووية.
إذ من الواضح بشكل جلي اليوم أنّ اتفاق الضمانات الأمنّية المكتوب هذا لم ينفع أوكرانيا في شيء، فقد قامت روسيا باحتلال جزء من أرضها والعبث بالجزء الآخر، والجانب الأمريكي يرفض حتى مد أوكرانيا بالأسلحة لمواجهة العدوان الروسي إلى هذه اللحظة.
ثالثها: السعي إلى إيجاد حلول عادلة لقضايا المنطقة الإقليمية
تشهد منطقة الشرق الأوسط منذ انطلاق شرارة ثورات الربيع العربي في أواخر عام 2010 حالةً من الغليان وعدم الاستقرار في عددٍ من الدول، لا سيما في سوريا وليبيا وكذلك في مصر، كما يصادف موعد انعقاد قمة كامب ديفيد الأمريكية-الخليجية، الذكرى السنوية السابعة والستين لنكبة الأراضي الفلسطينية المحتلة.
في ظل التغيرات التي تشهدها المنطقة، ومبادرة المملكة العربية السعودية لاستعادة مكانتها الإقليمية بعد انخراط الجيل الثالث- جيل الشباب- الذي يُمثِّل أحفاد الملك المؤسِّس عبد العزيز آل سعود في مؤسسة الحكم، ستكون رسالة القادة الخليجيين الثالثة لأوباما: أنهم قادرون على أخذ زمام المبادرة لإيجاد حلول لمشاكل المنطقة، وأن الدور الذي ينبغي للولايات المتحدة أن تؤدِّيه من الآن فصاعداً هو دور "الداعم" وليس دور "المخلِّص". ولعلَّ ذلك ما تمَّ تجسيده بالفعل من خلال الإعلان- من واشنطن- في 26 من مارس 2015 عن تشكيل تحالف دولي بقيادة المملكة العربية السعودية لمواجهة جماعة الحوثي؛ التي انقلبت على الشرعية في اليمن؛ حيث يتضح أن دول الخليج باتت قادرةً على اتخاذ المبادرة، وتحمُّل تبعاتها عندما تشعر بالخطر يهدِّد أمنها ومصالحها([22]).
المحور الثالث: أهم بنود قمة كامب ديفيد2
حري بالذكر أن أولى الرسائل التي وصلت إلى أوباما حتى قبل الاجتماع هي مستوى التمثيل الذي اقتصر على القادة من الكويت وقطر، في حين مثلت السعوديةَ والبحرين والإمارات وعمان قيادات من الصف الثاني، والأسباب تكاد تعرف[23]:
1- البعض يرى أن الدول الخليجية خابَ أملها في واشنطن بعد هبوط وتيرة العداء بين الأخيرة وطهران وشعورِهم بتخلي البيت الأبيض عن حلفائه العرب التقليديين في مقابل نجاحِ أوباما في ختام ولايته الرئاسية باتفاق مع إيران.
2- أن هذه الدول لم تعد تنتظر الأوامر الأمريكية بعد بداية عواصفها، وإثبات قدرتها على التحرك العسكري منفردة([24]).
ملفات فوق طاولة القمة تضم:
أولاً: وقبل كل شيء الإيرانفوبيا والمخاوف الإقليمية والمتمثلة بتمددها في المنطقة العربية.
ثانياً: النووي الإيراني والقلق الخليجي من توقيع اتفاقية تزيح الستار عن العقوبات، وتمكن طهران من استعادة أموالها في المصارف الغربية، وما يمثله ذلك من تهديد للأمن القومي العربي، بحسب رأي البعض، وهو ما لا تريده أطراف إقليمية، أهمها الرياض.
ثالثاً: ملف الإرهاب الشائك وتفرعاته، حيث الخلاف على ترتيب الأولويات في سوريا خاصة، وفي اليمن والعراق، ففي حين تريد دول إقليمية إسقاط حكم رئيس النظام السوري بشار الأسد ثم مكافحة الإرهاب، يوجد في الطرف المقابل من يريد القضاءَ على الإرهاب أولاً، ومن ثم الحديث عن أي ترتيبات سياسية للبلاد، إضافة لتداعيات الحرب في اليمن وغارات التحالف على ما تعتبره الرياض أذرعاً إيرانية، وبالطبع يبقى العراق بمعادلاته شبه مستحيلة الحل موضوعاً للبحث.
رابعاً: تعزيز التعاون العسكري بين واشنطن ودول الخليج، ومساعدة الحلفاء الخليجيين على إقامة نظام دفاعي إقليمي للحماية من الصواريخ الإيرانية المفترضة، وقد يصحبها تعزيز الالتزامات الأمنية وصفقات سلاح جديدة والمزيد من التدريبات العسكرية المشتركة، كما سيكون بحث دور القوة العربية المشتركة وأين وكيف سيتم استخدامها بعد اليمن.
وخلال القمة توصل الطرفان إلى الآتي:
1- ركز البيان المشترك على علاقات الشراكة والتحالف التي تجمع الطرفين؛ الخليجي والأمريكي، وأبرز بوضوح التزام أمريكا القاطع بحماية أمن الدول العربية الخليجية من العدوان العسكري والإرهاب؛ ومشدداً على وحدة وسلامة أراضيها. وفي رسالة قوية إلى إيران، اتفقت الأطراف على قيام نظام أمن إقليمي واسع للدفاع ضد الصواريخ الباليستية، بحيث يشمل نظاماً للإنذار المبكر، وتدريبات مشتركة ضد التهديدات غير التقليدية مثل الإرهاب والهجوم الإلكتروني، وزيادة التعاون في مجال الأمن البحري.
في هذا السياق، يتضمن البيان المشترك: «ستستخدم أمريكا كل وسائل القوة لحماية مصالحنا في منطقة الخليج وردع ومواجهة العدوان الخارجي ضد شركائنا وحلفائنا، كما فعلنا في حرب الخليج، وبشكل لا لبس فيه». ويقول البيان في موضع آخر بوضوح أيضاً: «وفي حال قيام عدوان أو التهديد بعدوان، ستكون أمريكا مستعدة مع شركائها في دول "مجلس التعاون الخليجي" على وجه السرعة لتحديد الفعل المناسب باستخدام كل الوسائل المتاحة، بما فيها القوة العسكرية، للدفاع عن شركائنا في دول المجلس».
وتتلخّص الإجراءات الأمريكية المقصودة، التي جاءت في ملحقٍ خاصٍّ، في: تطوير نظام دفاعي صاروخي باليستي مشترك ومتكامل بين دول مجلس التعاون كلها، بما في ذلك نظام إنذار مبكر بمساعدة فنية أمريكية، وتركيز مبيعات الأسلحة وتسريعها، وزيادة التدريبات والمناورات العسكرية المشتركة ضد التهديدات الخارجية وضد الإرهاب، وتعزيز أمن الشبكات الإلكترونية ضد أعمال القرصنة، وتعزيز الأمن البحري، وتدريب القوات الخاصة والأجهزة الاستخباراتية الخليجية[25].
ويعود البيان للتأكيد بوضوح أكبر: «ستعمل أمريكا ودول "مجلس التعاون" بكل الوسائل ضد نشاطات إيران لزعزعة الاستقرار في المنطقة، وقد شددوا على حاجة إيران إلى الانخراط في المنطقة طبقاً لمبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام وحدة وسلامة الأراضي بالاتساق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة»([26]).
بمعنى أن دول الخليج حصلت على تعهدات لا لبس فيها بحماية أمنها القومي من التدخلات الإيرانية، ولكنها لم تحصل بأي شكل من الأشكال على تعهدات بتقليص دور إيران الإقليمي.
وعليه؛ يمكن القول بأن قمة كامب ديفيد قد أكدت التغير الحادث في العلاقات بين دول الخليج العربي والولايات المتحدة الأمريكية منذ الثورات العربية، فهي كانت بمنزلة إعادة توضيح لما يمكن أن تقدمه إدارة أوباما لدول الخليج في الفترة المتبقية من ولايتها، أكثر منها نقل رسائل محددة من إيران لدول الخليج، فعلى خلاف قمة كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل التي عقدت في 1978، فإن هذه القمة لم يحضر فيها الطرف الثاني بالنسبة لدول الخليج وهو إيران، ومن ثم لم يصدر عنها ما يلزم إيران، أو ما تتكفل الولايات المتحدة بإلزام إيران به.
إلى جانب ذلك، يوجد تصور لدى الإدارة الأمريكية بأن التهديد الحقيقي الذي تواجهه دول الخليج لا ينبع من إيران، وإن كان يتم ترديد روايات بأن إيران مسؤولة عن مشاكل الأمن في الخليج، حيث أشار باراك أوباما في مقابلة مع توماس فريدمان قبل كامب ديفيد إلى أن ما تحتاجه هذه الدول هو "تقوية بنية السياسة فيها، على نحو يجعل الشباب السني يشعر بأنه يحصل على شيء يختاره بخلاف داعش. أعتقد أن التهديد الأكبر لا ينبع من احتمال اجتياح إيران لهذه الدول، وإنما من عدم الرضا الداخلي"، ورغم عدم نص البيان الختامي للقمة أو الملاحق الخاصة به على هذه القضية، فإنه يبدو أنه تم تداولها بشكل ما، حيث نشرت عدة مقالات في الصحف الخليجية بعد القمة تستنكر هذا الموقف من أوباما)[27](.
وفي مقابل التعهدات الأمريكية، فقد تضمن البيان تعهدات من دول الخليج مقابل أمريكا كالتالي: «قرر القادة زيادة تعاونهم في مجال مكافحة الإرهاب وخصوصاً تنظيم "الدولة" و"القاعدة" لردع ومنع الهجمات الإرهابية، مع إيلاء أهمية خاصة لحماية البنية التحتية الحساسة وتوسيع الأمن الحدودي والبحري ومحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ودعم المقاتلين الأجانب ومواجهة التطرف العنفي بكل أشكاله».
وعليه؛ يمكن القول بأن ما يقلق الحلفاء الخليجيين هو موقف أوباما ولغته المواربة تجاه إيران، وبخاصة مع رفض إدارته توقيع اتفاقية دفاع مشترك مع مجلس التعاون؛ فقد كان لافتاً تصريح أوباما في المؤتمر الصحافي بُعيد انتهاء أعمال قمة كامب ديفيد، إذ قال: "دعوني أكون واضحاً جداً هنا: الغرض من أي تعاون استراتيجي ليس إدامة مواجهة طويلة مع إيران، أو حتى تهميش إيران".
ولأنّ أي اتفاق نهائي محتملٍ مع إيران سيبقي على البنية التحتية النووية الإيرانية قائمة، فضلاً عن احتفاظها بأجهزة طرد مركزي ذات قدرة محدودة على تخصيب اليورانيوم لمدة 15 عاماً، ولأنّ احتفاظها بمهاراتها التقنية النووية (know-how) وقدرتها على تخصيب اليورانيوم سوف يمكّنها من تصنيع قنبلة نووية في المستقبل إذا قررت ذلك، فإنّ بعض الدول الخليجية ألمحت إلى أنها قد تسعى لتطوير برامج نوويةٍ خاصةٍ بها. وبهذا، فإنّ أكثر ما يقلق إدارة أوباما هو إطلاق سباق تسلحٍ نووي في المنطقة، خصوصاً مع إعلان السعودية أنها ستسعى للحصول على قدرات نووية مساوية لأي قدرات نووية تمتلكها إيران بموجب أي اتفاق نهائي. ومع أنّ الولايات المتحدة تعارض حصول سباق تسلحٍ نووي في المنطقة، فإنها لا تقدِّم في الوقت نفسه ضمانات كافية وذات موثوقية عالية لحماية دول الخليج العربية في حال امتلكت إيران سلاحاً نووياً في المستقبل، ومثال ذلك أنّ إدارة أوباما رفضت أن تشمل الخليج العربي ضمن مظلتها الحمائية النووية([28]).
2- أما بالنسبة للقضايا الإقليمية فقد وضع البيان المشترك حدوداً أمريكية واضحة لتوازن القوى الإقليمي الراهن وقطع الطريق على محاولات تعديله جذرياً، حيث أورد البيان فقرة لها مغزاها العميق: «قرر المجتمعون اعتماد مبادئ مشتركة يأتي من ضمنها الاعتراف المتبادل بأنه لا حل عسكرياً للحروب الأهلية في المنطقة، التي يمكن حلها فقط بالوسائل السياسية والسلمية واحترام سيادة كل الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية»، بمعنى أن التعامل مع القضايا الإقليمية يتم بالمفرق وليس كرزمة شاملة، ما يعني تثبيت توازن القوى الإقليمي المختل لمصلحة إيران، مع السعي لتعديله نسبياً بوسائل غير عسكرية، ويظهر ذلك بوضوح في ما يخص العراق؛ إذ: «أكد القادة التزامهم بمساعدة الحكومة العراقية والتحالف الدولي في حربهم ضد تنظيم "الدولة". وأكدوا على ضرورة تعزيز العلاقات بين دول "المجلس" والحكومة العراقية استناداً إلى مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام سيادة الدولة. وشجعوا الحكومة العراقية على الوصول إلى مصالحة وطنية حقيقية عبر حل مظالم كل مكونات المجتمع العراقي من طريق الإصلاحات التي تمت الموافقة عليها الصيف الماضي، والتأكد من أن كل الجماعات المسلحة تعمل تحت الرقابة المشددة للدولة العراقية». بمعنى أن