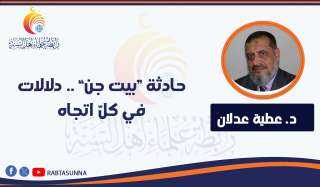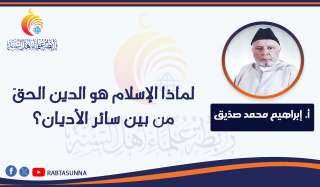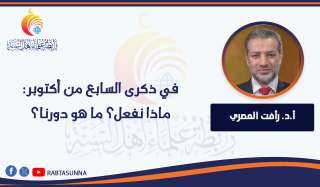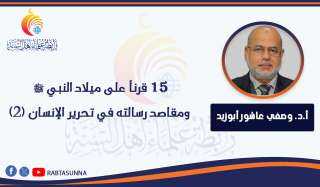في الذكرى التسعين لاستشهاد الشيخ عزّ الدين القسّام: العالمُ السوريُّ الذي أشعل ثورةَ فلسطين قبل أن تبدأ


تمضي التسعون عامًا منذ ارتقى الشيخ المجاهد عزّ الدين القسّام شهيدًا في أحراش يعبد يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1935، لكنّ اسمه ما زال حيًّا في وجدان الأمّة؛ رمزًا لالتقاء العلم بالجهاد، ولتحوّل الخطبة إلى بندقية، والكلمة إلى ثورة، والشيخ الهادئ المتواضع إلى قائدٍ يهزُّ عروشَ الاحتلال من جبلةَ الساحل السوري إلى جبال جنين في فلسطين.
من جبلة إلى الأزهر: تشكُّل الوعي والعزيمة
وُلد محمد عز الدين بن عبد القادر بن مصطفى بن يوسف بن محمد القسام عام 1882م في بلدة جبلة التابعة لمحافظة اللاذقية، في بيتٍ عرف بالطريقة القادرية، وبالانتماء إلى سلاسل العلم والتصوّف؛ حيث كان الناس يَفِدُون من العراق لزيارة أضرحة أبيه وجدّه، غير أنّ الفتى الذي تربّى في أحضان هذه البيئة هو من وقف لاحقًا يحذّر من الغلوّ في القبور، وينهى عن قصدها للتبرّك والذبح والتمسّح، ناصرًا للتوحيد ومصحّحًا لمسار التدين الشعبي.
تعلّم في الكتّاب، وقرأ القرآن والكتابة والحساب، وتتلمذ على الشيخين سليم طيّارة وأحمد الأروادي في زاوية الإمام الغزالي بجبلة، ولمّا رأى أبوه شدّة رغبته في العلم أرسله إلى الجامع الأزهر سنة 1896 وهو في الرابعة عشرة، هناك عاش ثماني سنوات في ظلال حلقات العلم الحرّ قبل نظام المراحل والامتحانات، ينهل من الفقه والتفسير والحديث والأصول واللغة، ويتشرّب في الوقت نفسه أجواء النهضة الفكرية والسياسية في مصر: أصداء الثورة العرابية، وأثر الإمام محمد عبده ومدرسة جمال الدين الأفغاني، وحركات الإصلاح التي ربطت بين تجديد الدين والنهضة السياسية.
في القاهرة تبلورت معالم شخصيته: شيخٌ يربط بين العلم والعمل، يكره الاتكاليّة والذلّ؛ حتى إذا انقطع عنه وعن صاحبه عزّ الدين التنوخي العطاء، لم يقبلا سؤال الناس، بل أعدّ التنوخي الحلوى، وكان القسّام يبيعها في الشوارع ليتعلّم ومعه كرامته، في تجسيد حيّ لقول النبي ﷺ: "لأَنْ يَحْتَطِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً علَى ظَهْرِهِ، خَيْرٌ له مِن أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا فيُعْطِيَهُ أَوْ يَمْنَعَهُ".
المصلحُ الاجتماعيُّ في جبلة: من نقد الإقطاع إلى صناعة الوعي
عاد القسّام إلى جبلة معلّمًا وخطيبًا وداعية إصلاح. أول ما بدأ به مراجعةُ الأعراف الفاسدة: رفض أن يذهب إلى "الأفندي ديب" صاحب الأراضي التي تعمل فيها أسرته ليهنّئه بعودته، كما هي عادة الإقطاع، وقال إنّ السنة أن يأتي المقيمُ لزيارة العائد من السفر، لا العكس؛ فكانت تلك شرارةَ مواجهةٍ مبكّرة مع طبقة الأفندية الذين يملكون الأرض ويحكمون الفلاحين بأحكامٍ جائرة ويأكلون ثمار تعبهم.
فتح مدرسة في قريته سنة 1913، قسمها إلى تعليمٍ نهاريّ للأطفال ومسائيٍّ للكبار، وواصل التدريس في جامع إبراهيم بن أدهم، وأمسك بزمام خطبة الجمعة في جامع المنصوري، فازدحم عليه الناس من القرى والبلدات لسماع خطبٍ جديدة في موضوعها وأسلوبها: تخاطب هموم الفلّاحين والعمّال، تفضح الظلم الاجتماعي، وتحدّث عن الأمة الواحدة وقضية المسلمين الكبرى.
تميّز نهجه الإصلاحي بخصلتين متلازمتين: نشر العلم لكسر الجهل الذي يعدّه مرتع الظلم، وإحياء كرامة الفقراء في وجه الإقطاع؛ فالعلم عنده ليس زينةً للنخبة، بل سلاحٌ في يد المستضعفين ليعرفوا دينهم وحقوقهم معًا.
من طرابلس الغرب إلى جبال صهيون: الجنديُّ الذي لم يعرف الحياد
ما إن حاصرت إيطاليا طرابلس الغرب سنة 1911 حتى ثار أهل الشام غضبًا، وكان عزّ الدين القسّام في طليعة من فجّر الحماس بين الناس، فجمع التبرّعات، وجنّد مئات الشباب، وتواصل مع الحكومة العثمانية لنقل المتطوّعين عبر ميناء إسكندرونة. تأخّرت السفن، لكنّ عزّ الدين لم يتراجع؛ فقد انتقل سرًّا إلى ليبيا، وأوصل التبرعات، والتقى عمر المختار، وتشبّع أكثر بمعنى الجهاد ضد المستعمر.
لمّا اندلعت الحرب العالمية الأولى تطوّع في الجيش العثماني، وأُرسل إلى معسكر جنوب دمشق، وحين أعلن الشريف حسين ثورته على الدولة العثمانية رفض القسّام المشاركة في قتال أخيه العربي، مع تمسّكه بالولاء للخلافة؛ فآثر العودة إلى بلده سنة 1916، بعيدًا عن صراعٍ رأى فيه انكسارًا للأمة لصالح المستعمر.
وحين احتلّ الأسطول الفرنسي اللاذقية والساحل السوري بعد الحرب، أدرك صحة رؤية الإصلاحيين الذين حذّروا من التلاعب البريطاني - الفرنسي بمصير البلاد، وهنا ظهرت روح القسّام الكاملة: لا تردّد في الفداء، ولا مهادنة مع المحتلّ، باع بيته ليجهّز نفسه وسلاحه، ورفض عروض التهدئة والمناصب التي قدّمتها له فرنسا، وأرسل إلى لجنة كراين الأميركية رسالة عملية: لا وصاية على هذه البلاد من أحد، وحقّ تقرير مصيرها لأهلها لا للدول المنتدِبة.
قاد من جبال صهيون والعلويين وحلب موجات مقاومة أقضّت مضاجع الاحتلال؛ وعندما ضاقت دائرة المطاردة وأُريق الدم في القرى عقابًا للفلاحين الذين آووا المجاهدين، صدرت بحقه أحكام بالإعدام، ورُصدت الجوائز للقبض عليه حيًّا أو ميتًا، وعندها رأى أنّ بقاءه في الساحل السوري سيجرّ مزيدًا من المذابح على الأبرياء، فشدّ الرحال سرًّا إلى حيفا، ليبدأ فصلًا جديدًا من الجهاد تحت انتدابٍ جديد.
في حيفا: منبرٌ، وعصبةٌ سرّية، وثورة تتكوّن ببطء
وصل القسّام إلى فلسطين في بدايات سنة 1921، واختار حيفا مركزًا لإقامته؛ فهي مدينة العمال والفقراء الذين هُجّروا من قراهم، وقاعدة للأسطول البريطاني، ومنصة متقدّمة لمشروع التهويد. كانت البلاد قد دخلت رسميًّا تحت الانتداب البريطاني، الذي لبس ثوب الوصيّ "المتحضِّ"، وهو يسير خطوة خطوة لتنفيذ وعد بلفور بإقامة وطن قومي لليهود.
وسط حالة الالتباس والآمال الكاذبة بوعود بريطانيا، حسم القسّام موقفه مبكّرًا: الاحتلال البريطاني هو العدوّ الأول لفلسطين، والوجود الصهيوني خطر وجوديّ يتغذّى من هذا الانتداب، بدأ بالتعليم في المدارس الإسلامية، ثم تولّى الإمامة والخطابة في جامع الاستقلال سنة 1925، ورئاسة فرع جمعية الشبان المسلمين في حيفا سنة 1928.
اتخذ نضاله ثلاثة مسارات متشابكة:
– اجتماعيّ تعليميّ: تدريس، محو أمية، ودروس ليلية للعمال والفلاحين.
– دعويّ إصلاحيّ: خطب ومواعظ في المساجد الكبرى، توعيةٌ بالعقيدة والعبادة والكرامة الاجتماعية.
– مقاومة فكرية وتنظيم سرّي: مواجهة البهائية والقاديانية والتنصير، وفي الخلفية تأسيس "العصبة القسامية"؛ مجموعات سرّية صغيرة مدرّبة على السلاح والعمل الفدائي.
كان يختار رجال العصبة بعناية؛ يختبر صدقهم وثباتهم، يوصيهم بالتخفّي عن أعين الاحتلال والعصابات الصهيونية، ويوزّعهم خلايا لا يعرف بعضها بعضًا. منذ 1928 بدأت هذه المجموعات تنفّذ عملياتٍ ضد الإنجليز في حيفا وضواحيها، وتحافظ في الوقت نفسه على سرية كاملة، حتى إنّ أقرب النخب حول القسّام لم تكن تعرف تفاصيل ما يجري.
في المنبر، ظلّ القسّام يكرّر أن الثورة المسلّحة هي السبيل الوحيد لإنهاء الانتداب ومنع قيام دولة صهيونية، في وقت كان معظم النشاط الوطني الفلسطيني يقتصر على المظاهرات والمؤتمرات والعرائض. كان يدرك أنّ خطّ المقاومة المسلّحة غريبٌ على المزاج العام، لكنّه كان يؤمن أنّ التاريخ لا يصنعه المعتدلون المرهقون بالمفاوضات، بل الطليعة التي تدفع ثمن البدء.
معركة يعبد: شيخٌ يموت واقفًا ويبعث ثورةً بعد موته
مع مطلع سنة 1935 اشتدّ الخناق على القسّام؛ الرقابة عليه وعلى محيطه تضاعفت، والهجرة اليهودية بلغت أرقامًا غير مسبوقة، وقرى كثيرة فقدت أرضها لصالح المستوطنات. خشي أن تُستأصل نواة التنظيم قبل أن تتحوّل إلى ثورة، فقرّر أن يخرج إلى الجبال ويعلن حركة الجهاد علنًا.
في أكتوبر 1935 ألقى خطبته الأخيرة في جامع الاستقلال، تلك الخطبة التي سيحفظها التاريخ: "أيها الناس، لقد علّمتُكم أمور دينكم حتى صار كل واحد منكم عالمًا بها، وعلّمتُكم أمور وطنكم حتى وجب عليكم الجهاد. ألا هل بلّغت؟ اللهم فاشهد. فإلى الجهاد أيها المسلمون، إلى الجهاد أيها المسلمون". ثم اختفى؛ لم يره أحد بعد ذلك في شوارع حيفا.
اتجه مع ثلة من أنصاره إلى منطقة جنين، يتحرّكون بين القرى؛ يخطّطون لعمل منظّم طويل النفس. لكنّ خطأ فرديًّا في قرية زرعين أدّى إلى مقتل جنديّ بريطاني، فاشتدّت الملاحقة، وتكاثرت العيون والجواسيس، وبدأ الطوق يضيق حول المجموعة.
في 19 نوفمبر 1935 اكتشفت قوات الاحتلال مكانه قرب نزلة الشيخ زيد في أحراش يعبد، فهاجمته مع عشرة من رجاله بعشرات الجنود، ثم بمئاتٍ أحاطوا بالغابة من كلّ جانب. رفض الشيخ الاستسلام، وقاتل مع أصحابه من الصباح حتى العصر. أُصيب وارتقى شهيدًا برصاصة في جبينه، ومعه ثلاثة من رفاقه، وجُرح اثنان وأُسر أربعة. كانت تلك المعركة الصغيرة نواةً انفجرت بعدها بأشهر في صورة الثورة الفلسطينية الكبرى سنة 1936، التي استمرّت أربع سنوات، وغيّرت وجه الحركة الوطنية الفلسطينية.
بعد تسعين عامًا: ماذا يبقى من القسّام؟
لم يكن عزّ الدين القسّام قائدَ معركةٍ واحدة، ولا مجرّد رمزٍ عاطفيّ، بل كان مدرسةً متكاملة: في العلم والتربية، في الإصلاح الاجتماعي، وفي تنظيم المقاومة، علّم الأمة أنّ:
"الاحتلال لا يُفهم إلا بوصفه عدوًّا أوّل لا شريكًا في إدارة البلاد، وأن العلم الشرعي إذا لم ينتهِ إلى كلمة حقّ تُقال وسلاحٍ يُحمَل فهو شهادة على صاحبه لا له، وأنّ الثورة ليست نوبة غضب عابرة، بل بناء بطيء في العقول والقلوب، ثم اندفاعة واعية نحو الشهادة أو النصر".
في الذكرى التسعين لاستشهاده، وفلسطين ما زالت تنزف، وغزّة ما زالت تُحاصر وتُقصف، والقدس ما زالت تُهوَّد؛ تبدو سيرة القسّام رسالةً متجدّدة: لا خلاص لشعبٍ يرضى أن تُختزل قضاياه في موائد التفاوض، ولا لعالمٍ يكتفي بالفتيا والوعظ وهو يرى أمّته تُساق إلى التمزيق.
رحم الله الشيخ عزّ الدين القسّام؛ العالمَ الأزهريَّ المصلحَ والمجاهدَ، الذي قاد ثورةً استشهد قبل اشتعالها، فكان دمُه هو الشرارة الكبرى، وكان اسمه – ولا يزال – رايةً لكل مقاومةٍ صادقة في فلسطين وخارج فلسطين.